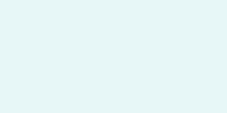حول البحوث الثلاثة
سيتم – إن شاء الله تعالى – عرض أبحاث في الميادين النفسية، و الاجتماعية، و الظواهر فوق الطبيعية؛ تكون متسلسلة و مترابطة الحلقات، و ذلك على وفق تصنيفها في المصنفات الأصلية لدى الباحث .
و ينتبه إلى أن أية نشرة لم يتم رفعها من الموقع، فهي تحت المراجعة و التصرف: تعديلا، أو زيادة، أو نقصا؛ و لذا فمن المستحسن أن تتكرر الزيارة للموقع، للاطلاع على ما نُشِر حتى يتم رفعه، و نشْر جديد خلفه !
هذا.. و عرض الأبحاث المذكورة في هذا الموقع، إنما هو للإطلاع فحسب؛ و لا يسمح بنسخ شيء منها أو نشره – بأية وسيلة – إلا بإذن من المالك !
( يراجع "التحذير" في الكتابة الحمراء أعلاه يسارا )
أما العنوان الذي تعرض تحته _ تلك الأبحاث _ أو تنشر، فهو:
تقديم البــــــدائل الإسلامية
في
الميادين النفسية؛ و الاجتماعية؛ و الظواهر فوق الطبيعية
( معرفيا و تربويا و عياديا )
إنها دراسات مفصلة لـ ظواهر كونية طبيعية، و فوق الطبيعية: ( نفسية و اجتماعية و بيئية ) في ضوء الكتاب و السنة، و توضيحات من علوم الظواهر الدنيوية .
و فيما يلي كلمة مهمة، بين يدي العرض للأبحاث المذكورة، و هي مجلاة في فقرتين بعض التجلية :
أ/ التأصيل الإسلامي – للعلوم النفسية و الإجتماعية – من أولويات الصحوة الإسلامية:
إن العلوم النفسية و الاجتماعية السائدة الآن في الغرب، و كذا فيما يتبعه من البلاد، و ما يواليه من الأنظمة.. قد نمت – تلك العلوم – و تأصلت في أوربا، في ظل أجواء نفسية و فكرية معينة أثرت في توجيهها؛ و هي أجواء نتجت عن الصراع بين الكنيسة، و بين العلوم النظرية و التجريبية؛ أو بين الدين و الحياة هنالك بصفة عامة . و إن هذا الصراع قد خلَّف بصماته الواضحة على تلك العلوم، فنشأت إما معادية للدين، أو- في القليل – مبتعدة عنه، متنصلة من الاتصال به، أو الاستمداد من وحيه . ثم أصبح هذا في حس الناس هناك هو "المنهج العلمي" الذي يجب أن تسير عليه البحوث العلمية، و الذي تعتبر أية مخالفة له خللا في الفكر، و نقضا "للروح العلمية" و "الموضوعية" و إفساداً للبحث العلمي !!
و هذا الموقف الذي يقفه الغرب في تناوله للعلوم النفسية و الاجتماعية – و غيرها كذلك – ليس موقفا علميا في حقيقته، و إن أُلبِس ثوب العلم ! إنما هو موقف وجداني انفعالي في الحقيقة، له أسبابه الكامنة في مجرى حياتهم، و له تأثيره الخطير على "الحصيلة العلمية" التي أنتجها الغرب في هذه العلوم، على الرغم مما بذل في دراستها من جهد، و ما استحدث من أدوات؛ و على الرغم من محاولة وضع "ضوابط علمية" للبحث !
إن العالِمَ الغربي يتوهم في نفسه التجرد العلمي، و الدقة الموضوعية، في تناوله لهذه العلوم، و لا يتنبه إلى أنه قد دخل الساحة بمقررات مسبقة، تؤثر- بوعي منه أو بغير وعي- في طريقة تناوله للموضوع، و في النتائج التي يستخلصها من بحثه .. تلك المقررات هي وجوب إبعاد الدين و كل ما يستوحَى منه إبعاداً كاملا من نطاق البحث ! بل إنه يتصور أن اتخاذه هذا الموقف المسبق، و الإصرار عليه، هو الواجب الذي تفرضه عليه طبيعة البحث العلمي؛ و أن مدى دقة النتائج المستخلصة، و مصداقيتها، متوقف على مدى إخلاصه في أداء هذا الواجب " المقدس " !!
و هنا بالذات يفترق طريقنا – نحن المسلمين – عن طريقهم؛ أو يجب أن يفترق !
إن الظروف التي مرت بها أوربا – و أنتجت ذلك الانفصام بين العلم و الدين– ليست ظروفا عالمية ! و إنما هي ظروف خاصة بأوربا وحدها؛ و سببها هو الدين المحرف الذي فرضته الكنيسة ! و إن المعايير التي أنشأت تلك الظروف، هي كذلك معايير محلية خاصة، ليس لها صفة العموم، و لا صفة اللزوم . إنها ليست معايير "إنسانية" كما يحلو لأوربا أن تتصورها بدافع الغرور الذي أنشأه النجاح الحاضر للغرب، هذا الذي جعله يتوهم أن الغرب هو العالم ! و أن معاييره يجب أن تخضع لها البشرية كافة؛ و أن من اختلف عنها فهو المخطئ الذي ينبغي أن يعدّل موقفه، و ينقاد إلى "المعيار الصحيح" !
أما نحن فنقول: إن الظروف التي مر بها الغرب، و أنشأت له معاييره الخاصة، ليست هي ظروفنا التي عشناها في ظل الإسلام، سواء في فترة ازدهاره و عزته، و ازدهار الحضارة الإسلامية، و الحركة العلمية الإسلامية؛ أو في ظل الانحسار الذي طرأ على العالم الإسلامي .. حتى أوصل الأمة إلى حضيضها الذي وصلت إليه، فصارت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم "غثاء كغثاء السيل"؛ أو في ظل الصحوة الإسلامية المباركة التي تبشر بالخير، رغم تكالب العالم كله على محاولة القضاء عليها !
في جميع هذه الأحوال الثلاثة كانت ظروفنا مختلفة عن ظروف الغرب؛ فلا عجب أن تكون معاييرنا مختلفة عن معاييره؛ و أن يكون تناولنا للعلوم النفسية و الاجتماعية – و غيرها كذلك – مختلفا عن التناول الغربي في أسسه و قواعده؛ و إنِ التقى معه في بعض الجزئيات، أو حتى في كثير من الجزئيات التي تتخذ صورة أبحاث معملية و تجريبية . ذلك أن الخلاف الجوهري ليس في إجراء التجارب المعملية و رصد نتائجها، إنما هو في تفسير الظواهر النفسية و الاجتماعية و البيئية، و تأصيلها المستمد أساسا من تصورنا للكيان الإنساني، و لغاية الوجود الإنساني .. و هنا يقع الخلاف، و هنا يكمن الدافع إلى ضرورة التأصيل الإسلامي لهذه العلوم !
و في الغربة الثانية للإسلام – التي أخبر عنها رسول الأنام – عليه الصلاة و السلام – بقوله : << بدأ الإسلام غريبا، و سيعود غريبا كما بدأ >> – و التي نعايشها في واقعنا المعاصر، فإن كثيراً من الناس – من الذين درسوا هذه العلوم على طريقة الغرب و تأثروا بها – يستنكرون هذه المحاولة، و يرون فيها خروجا عن "المنهج العلمي" الذي ينبغي اتباعه في تناول هذه العلوم !
و قبل ظهور الصحوة الإسلامية الحالية لم يكن أحد من "المثقفين" يطيق مجرد الاستماع إلى الدعوة التي تهدف إلى إنتاج "أدب إسلامي" أو "اقتصاد إسلامي" أو "علم اجتماع إسلامي" أو "دراسات نفسية و تربوية إسلامية" .. و كانت تبدو بالنسبة لهم خبلا لا يقدم عليه عاقل، و انحرافا خطيرا عن الجادة ! و لكن وجود الصحوة أمراً واقعا في الحياة الإسلامية، قد خفف كثيرا من العجب و الاستنكار، الذي كانت الدعوة تواجه به في أول الأمر، و إن لم يخفف من حدة الحرب الموجهة للدعوة، على أمل تعويقها، أو القضاء عليها !
إنه لا بد من العمل الجاد و الدؤوب لإزالة الغربة عن الإسلام في ميدان من ميادينه الأصيلة، التي ينبغي للصحوة أن توجه إليها اهتمامها، و هو ميدان النفس، و الاجتماع، و التربية .. الذي يحاول أعداء الإسلام بكل جهدهم أن يمنعوا أهل الإسلام من دخوله أو التمكن فيه ! (( يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ )) .
إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن المستقبل للإسلام، و بأن كل المقاومة التي يقوم بها أعداؤه، لن تمنع تمكنه مرة أخرى في واقع الأرض
" … و لكن القرون الثلاثة الأخيرة شهدت في العالم الغربي على أقل تقدير انقساما خطيرا في طريقة رؤيتنا للعالم المحيط بنا . فقد حاول العلم بسط احتكاره – بل سطوته المستبدة – على طريقةِ فهمنا للعالم، و انفصل الدين و العلم أحدُهما عن الآخر، بحيث صرنا كما قال الشاعر "وردزورث" لا نرى إلا القليل في "أمنا الطبيعة" التي نملكها ! لقد سعى العلم إلى الاستيلاء على عالم الطبيعة من الخالق (سبحانه و تعالى) ! فجزأ الكون إلى فرق، و أقصى "المقدس" إلى زاوية نائية ثانوية من ملكة الفهم عندنا، و أبعده عن وجودنا العلمي . و الآن فقط بدأنا نقدر العواقب المدمرة لهذا الأمر … " !
ثم يقول : " إن الثقافة الإسلامية – في شكلها التراثي- جاهدت للحفاظ على هذه الرؤية الروحية المتكاملة للعالم، بطريقة لم نجدها نحن- خلال الأجيال الأخيرة في الغرب – موائمةً للتطبيق . و هناك الكثير مما يمكن لنا أن نتعلمه من رؤية العالم الإسلامي في هذا المضمار " !
و في الختام يقول : "إننا – نحن أبناء الغرب – نحتاج إلى معلمين مسلمين يعلموننا كيف نتعلم بقلوبنا كما نتعلم بعقولنا" !!
إن الدلالة في هذه الكلمات واضحة .. فلقد بدأ بعض العقلاء في الغرب يدركون مدى التدمير الذي أحدثه الفصام النكد بين الدين و العلم؛ أو بين الدين و الحياة . و بدأوا يدركون أن المنهج الإسلامي في هذا المجال هو المنهج الصحيح .
و لكن لا يدفعنا الوهم أن نظن أن آثار هذا التحول ستطرق أبوابنا صباح الغد ! فما زال بين جموع الناس في الغرب و بين إدراك هذه الحقائق فجوة لا يعلم مداها إلا الله . و ما زال بين الغرب الصليبي و بين الإسلام من العداء التقليدي ما تحتاج إزالته إلى جهود لا يعلم مداها إلا الله جل جلاله !!
و لكن تبقى الدلالة واضحة بالنسبة للمستقبل .. فإن المستقبل للإسلام .. و مقتضى ذلك أن ندرك أن التأصيل الإسلامي للمعرفة – في جميع مجالاتها – ليس حاجة للمسلمين وحدهم في واقعهم المعاصر، إنما هو أمر لازم للبشرية كلها، ليخرجها من الظلمات إلى النور :
(( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً .. فَبَعَثَ اللَّـهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ * وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَ اللَّـهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ )) .
صدق الله العظيم.
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ و ممن يهتدون بكتابك و بسنة نبيك، و يستقيمون على الصراط المستقيم .
اهـ بتصرف طفيف، من مقدمة الكتاب القيم النفيس : (التأصيل …) الذي ألفه الأستاذ الكبير العلامة: محمد قطب، جزاه الله – عن الإسلام و المسلمين – خير الجزاء .
…………………………
الوحدانية و الانفصامية : ب/
المراد بهذا العنوان: هو بيان أثر عقيدة التوحيد الإسلامية، في إحداث التوازنات بين أمور متقابلة، في ضمير النفس الإنسانية، و ما ينتج عن ذلك – أو يترتب عليه – من اطمئنان نفسي، و استقرار اجتماعي ! و ذلك على عكس ما تحدثه العقائد الوثنية (الشركية) و الإلحادية، من انفصام في الشخصية، و اضطرابات في الأوضاع الإجتماعية:
((شَهِدَ اللَّـهُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿﴾ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّـهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّـهِ فَإِنَّ اللَّـهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿﴾ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّـهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّـهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ )) (( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَـٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ )) .
إن الإسلام هو دين الله الحق، الذي بعث به كل المرسلين، إلى كل الأقوام و الأمم من الثقلين ! بل [الإسلام] هو الدين الكوني، الذي يدين به الكون كله لله رب العالمين:
(( أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّـهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿﴾ قُلْ آمَنَّا بِاللَّـهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿﴾ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ )) .
فأما ما سوى الثقلين في هذه الأرض، فإسلامهم إسلام اضطراري؛ ( أي أنهم لا خِيَرة لهم في أمرهم كله ) ! فعن السماوات و الأرض قال الخلاق العليم: (( … ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ )) . و عن سكان السماوات أخبر أنهم: (( لَّا يَعْصُونَ اللَّـهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )) .
و أما بالنسبة للثقلين – خاصة في هذه الأرض – فلهم جانب اضطراري، شأنهم في ذلك كشأن بقية الكائنات الأرضية و السماوية، كما سبق ! كما لهم (أي: للثقلين) جانب اختياري، بحيث يكون منهم من يسلم، كما يكون منهم من يكفر: (( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَ مِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَ اللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )) (( وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَ مَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴿﴾ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَ إِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا )) . و بهذا الجانب الاختياري – من أمر الإنسان و الجان – يتعلق الحساب و الجزاء من الملك الديان !
إن هذا الدين [الإسلام] هو الوصفة الناجعة، لمعالجة النفس الإنسانية؛ إذ هو دين الفطرة، المنزل من عند خالقها و فاطرها – و هو فاطر السماوات و الأرض – فهو سبحانه العليم بمكونات النفس و خصائصها؛ الخبير بما يُصلحها و يَصلح لها:
(( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّـهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّـهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ )) (( وَ أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ )) .
إنه الدين الذي يجمع شتات النفس، و يوحد طاقاتها، و يوازن بينها، حتى لا يطغى جانب منها على جانب آخر؛ فلا يفرقها روحاً و جسداً منفصلين، متنافرين؛ لأن الإنسان – في الحياة – هو روح و جسد في آن واحد لا ينفصلان : (( و إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ۖ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ )) . و كذلك لا تفريق في الإسلام بين العقل و القلب، بحيث يختص الأول بالأفكار و البراهين؛ و يختص الثاني بالعواطف و الأهواء، كما هو شائع – قديما وحديثا – في الفكر الجاهلي، بجانبيه الروحي (الوثني)، و المادي (الإلحادي) .. كلا .. إن العقل في المنظور الإسلامي ليس عضوا مخصوصا في الجسد؛ و لذلك لم يرد في الوحي المحفوظ بصيغة اسمية؛ و إنما هو عمل القلب؛ و القلب ليس بالمضخة العضلية التي هي بين الضلوع ! بل هو المضغة المحفوظة في أصلب وعاء – في جسد الإنسان – هو الجمجمة ! فلشرف تلك المضغة وُضعت تاجا على رأس الكينونة الإنسانية !! : (( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ )) (( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِـهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَـٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ )) و في الحديث النبوي المشهور : << ألا و إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، و إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا و هي القلب ! >> . و لما < سئل ابن عباس : بم نلت العلم؟ أجاب: بلسان سؤول، و قلب عقول ! >
إن التفريق بين مكونات النفس، أو وضعها في غير موضعها، ذلك من عمل الجاهلية:
فالجاهلية الروحانية تهمل الجسد و تعذبه سعيا منها – بزعمها – إلى تطهير الروح، كما تفعل النحل المترهْبنة، و المتصوفة، في الشرق و في الغرب على السواء !
و الجاهلية المادية تهمل الروح و تتنكر لها، مهتمة بالجسد وحده؛ كما تفعل ذلك الجاهلياتُ التي ترفع شعار العلمانية (اللادينية)؛ أو شعار الليبرالية (الإباحية) ! إذ تضخم جانب الحس، و تنْكَب على شهوات الجسد، و تمعن في تزيين الأرض للمتاع و حسب، بينما تهمل الجانب الروحي، و تطمس من الإنسان جانبه النوراني الشفيف .
ثم إن الإسلام يوحد في حس الإنسان المسلم الموحد طريق الدنيا و الآخرة، فلا يفرقهما إلى طريقين مختفلين: طريق للدنيا على حدة، و طريق للآخرة على حدة .. كلا .. إنما هو طريق واحد، أوله في الدنيا، و آخره في الآخرة ! و كل عمل يعمله الإنسان الموحد هو للدنيا و الآخرة في ذات الوقت؛ إذ يؤديه في الدنيا، ثم يحاسب عليه هو ذاته في الآخرة، فتتصل الدنيا بالآخرة في ضميره و لا تفترقان، بل تتوازنان ! :
(( كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة )) (( وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّـهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّـهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ )) . و في الأثر: < اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، و اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا > . و من العبارات الجارية على ألسنة الواعظين قولهم : "إن الدنيا مزرعة الآخرة" ! فلا حصاد هنالك إلا لما تم زرعه ههنا !
و هكذا .. فلا يكون عمل المسلم في تعمير الأرض صارفاً له عن آخرته؛ و لا عمله للآخرة صارفاً له عن عمارة الأرض .. كما تصنع الجاهليات التي تفرق الطريقين، و تقسم الأعمال إلى قسمين: عمل للدنيا؛ و عمل للآخرة:
(( مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿﴾ كُلًّا نُّمِدُّ هَـٰؤُلَاءِ وَهَـٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿﴾ انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿﴾ لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّـهِ إِلَـٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا )) .
و لمزيد من البيان في حقيقة الترابط بين شؤون الدنيا و شؤون الآخرة – في التصور الإسلامي – أن يقال على سبيل المثال:
إن الصلاة التي هي أدخل الأشياء في عمل الآخرة – كما يبدو في ظاهر الأمر- لتؤدي مهمة معينة من أجل أمر المجتمع في الأرض، و هو تقويم السلوك الإنساني حتى يصبح فردا صالحا . و إن من الأفراد الصالحين يتكون المجتمع الصالح ! :
(( اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّـهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ )) . << أرحنا بها يا بلال >> .
و إن "الجنس" (شهوة الجماع) – الذي هو أدخل الأشياء في عمل الدنيا، كما يبدو في ظاهر الأمر كذلك – ليتصل بالآخرة ! حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: <<و إن في بُضع أحدكم لأجراً>>. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليأتي زوجه شهوة منه ثم يكون له عليها أجر؟! قال: <<أرأيتم إذا وضعها في حرام، أيكون عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال فله عليها أجر>> ! و لقد أمِر المسلم أن يذكر ربه عند إرادته مجامعة زوجه، فيقول : << بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، و جنب الشيطان ما رزقتنا >> ! فهذان مثالان .. لا الحصر . و ليلاحظ كذلك هذا الحديث النبوي الشريف: << حُبب إلي من دنياكم النساء؛ و الطيب؛ و جعلت قرة عيني في الصلاة >> ! و كذلك حديث: << أما إني اصلي و أنام؛ و أصوم و أفطر؛ و أتزوج النساء .. فمن رغب عن سنتي فليس مني >> !
فبهذا التوحيد و التوازن بين مكونات النفس الإنسانية، و باستقامتها على الهدى الآتي من لدن بارئها سبحانه، يحصل للقلب الاطمئنان، و للنفس السكينة، فيسعد الإنسان سعادة حقيقية، و يكون حيث خلقه ربه في الأصل، و هو في أحسن تقويم:
(( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلين ﴿﴾ – حين اختار التخلي عن منهج الله خالقه – إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ )) (( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّـهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ )) (( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿﴾ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ )) (( قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ والذين كفروا و كذبوا بئاياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )) .. فهذا .. في الإسلام ..
أما في الجاهليات الأرضية (الروحانية منها و المادية، قديمها و حديثها) .. فإن الإنسان يعيش في اختلال و اضطراب، ثم في انفصام و اكتئاب .. و قد ينتهي به الأمر إلى حالة من الجنون، و الجنون فنون !
و على العموم، فحالة أكثر الناس في الجاهلية المعاصرة يسودها الشقاء و التعاسة، و قد عُرف هذا العصر بأنه "عصر القلق و الأرق .. و الاكتئاب و الرُهاب"! و هو – حقيقة و واقعا – كذلك ! و صدق الله العظيم إذ قال في كتابه الكريم :
(( فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن اتَبِعَ هُدَايَ فلايضل و لا يشقى ۖ و من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ۖ و نحشره يوم القيامة أعمى ۖ قال رب لم حشرتني أعمى و قد كنت بصيرا ۖ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ۖ و كذلك تنسى ۖ و كذلك نجزي من أسرف و لم يؤمن بئايات ربه ۖ و لعذاب الآخرة أشد و أبقى )) .
و هكذا .. و بعد عرض ما ذكر يتضح كيف يوحد الإسلام بين شتى ألوان النشاط البشري، فلا يفرقها نشاطات مختلفة منفلتة، كل واحدة في طريق .. كلا.. إن الإسلام ليجمع بينها، لأنها في حقيقتها كلها صادرة من كيان نفسي موحد، و يجعلها كلها متصلة بالعقيدة و منبثقة عنها، فتتصل كلها في الأصل الواحد المشترك، و إن تعددت مجالات عملها، و تخصصت كل واحدة منها في اتجاه، و لأنها في النهاية تصب كلها في الكيان النفسي الموحد، و تؤثر كلها فيه في وقت واحد؛ ثم إنه يوازن بينها بالمنهج الرباني المفصل، الذي يعطي كل جانب غذاءه الحق، و القدر اللازم له في حياة الإنسان؛ فلا يطغى منها جانب على جانب، فيختل توازن الإنسان، و يعيش في اضطراب، ثم في انفصام الشخصية ! فالجنون بعد ذلك !! كما هو الوضع الغلاب على أكثر النفوس في الجاهلية المعاصرة، كما ذكر آنفا !
و بذلك التوحيد و الشمول و التوازن الذي يلتقي بالفطرة في سوائها، يمكن للإنسانية أن تنطلق عاملة في واقع الأرض بانية معمرة، تقيم الحق و العدل، و تؤسس الحضارة الصحيحة، و تقوم بدور الخلافة الراشدة عن الله في الأرض:
(( وإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ )) (( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ )) (( وَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّـهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا – أي كلفكم بعمارتها – فاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ )) .
هذا هو الإسلام؛ و هذا هو سر القوة الهائلة التي يمنحها لأتباعه حين يستقيمون عليه، فتتوحد طاقاتهم و تتوازن، و تنطلق كلها تعمل، لا تتعطل منها طاقة، فتستمد من الله القوة، و يمنحها تعالى إياها:
(( وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ۖ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ )) .
إن أعداء الإسلام يعلمون سر قوة المسلمين حق العلم، ذلك السر الذي يكمن في عقيدتهم و شريعتهم الربانية (التي يدينون بها لربهم سبحانه) و هو ما جعل منهم أمة ذات شخصية قوية – حين تلتزم و تستقيم على الهدى – :
(( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ )) (( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا )) .
و ذلك ما جعل أنفُس أعدائهم تفيض حقداً عليهم و حسدا لهم ! مما دفعهم ( أولئك الأعداء ) إلى إعلان الحرب عليهم، منذ أن نزل قول الحق تبارك و تعالى:
(( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا )) (( وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّـهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )) .
ولقد بدأوا الحرب منذ أول يوم لقيام الدولة الإسلامية في المدينة النبوية، و التاريخ يتضمن وقائع هذه الحرب الهائلة التي شنها المشركون من ناحية، و اليهود من ناحية؛ ثم النصارى من ناحية ثالثة؛ بمجرد أن أحست الدولة الرومانية – المهيمنة في ذلك الإبان- بمولد الدولة الجديدة في الجزيرة العربية و استوائها على قدميها . و لا تزال حرب هؤلاء و هؤلاء للإسلام و أهله قائمة، حتى يأتي أمر الله، و هو يعني موعد النصر الشامل للحق على الباطل- أولا – في هذه الدنيا، قبل قيام الساعة ! كما يعني – ثانيا – موعد النصر الشامل للحق على الباطل في يوم الدين ! :
(( وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أُولَـٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّـهِ ۚ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) (( و يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم و لا هم ينظرون * فأعرض عنهم و انتظر إنهم منتظرون )) (( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك ... ؟ )) (( إنا لننصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد ... )) .. << لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، و لا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله و هم على ذلك ! >>
إن الحرب على الإسلام اليوم – كما هو معلوم للنابهين و المتتبعين – صارت حربا "عالمية" ! بحيث تكالبت عليه و على أهله كل قوى الشرك و الكفر، و النفاق و الفسوق ! كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون، إذ قال: << يوشك أن تداعى عليكم الأمم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها! قيل: أو من قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، و لكنكم غثاء كغثاء السيل، و لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، و ليقذفن الله في قلوبكم الوهن! قيل: و ما الوهن؟ قال: حب الدنيا و كراهية الموت >> !!
هذا هو حال عامة الأمة التي تنتسب إلى الإسلام ! و لكن هذا العموم ليس شاملا لكل أفرادها أو فئاتها، فهناك خير ضمن الركام الكثير! و لذلك الخير – و إن بدا قليلا – ستكون العاقبة يوما ما ! مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الآنف عن الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة .
و يصدق ذلك قول الله العظيم، في كتابه الكريم: (( .. كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّـهِ ۗ وَ اللَّـهُ مَعَ الصَّابِرِينَ )) و قوله: (( وَلَيَنصُرَنَّ اللَّـهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ )) و قوله: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّـهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴿﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّـهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴿﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّـهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿﴾ إِنَّ اللَّـهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ )) .
—————————————————
تنبيه : الآيات القرآنية تمت كتابتها باللون الأخضر تمييزا لها، و كل مقطع من سورة، هو موضوع بين قوسين مزدوجتين !
للاطلاع على موضوعات الأبحاث الثلاثة مفصلة، المدخل من هنا
تذكير: لايحق لك تنزيل أو تحميل أو نسخ، إلا بإذن من القيم على الموقع
و يمكنك إرسال تعليقك، أو استفسارك، من مدخل "للتواصل مع المركز" .